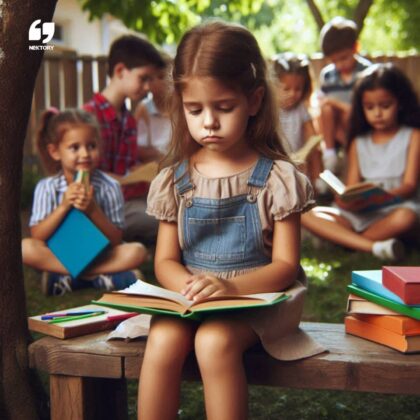“يلعب في الحي طوال الوقت.” تلك الحالة التي يعيشها الطفل عمران البالغ من العمر تسع سنوات، والمنحدر من مدينة الدرباسية. تصف والدته، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، حالة ابنها الذي درس الصف الأول فقط، وتوقف عن الدراسة منذ عامين، وذلك حين انتقل مع عائلته إلى حي جديد في المدينة، ولم يعاود الجلوس على مقاعد الدراسة مرةً أخرى.
تقول والدته إنّ العائلة انتقلت إلى حيٍّ جديد، الأمر الذي استوجب تسجيل عمران في مدرسةٍ أخرى، وبعد مرور عدّة أشهر على بدء العام الدراسي الجديد، رافق عمران زوجة عمّه إلى المدرسة بهدف تسجيله، إلا أنّ المدرسة رفضت ذلك بسبب مرور فترة طويلة على بدء العام الدراسي، مطالبةً بمعاودة تسجيله العام القادم.
في العام الثالث من عمر عمران المدرسيّ، حاولتْ العائلة مجدداً، ولمرةٍ واحدة، أن تصطحب طفلها إلى المدرسة، إلا أنه أبدى ردّات فعل، وصفتها الوالدة بـ “الغريبة”، تعبيراً عن رفضه للذهاب إلى المدرسة، واكتفت العائلة حينذاك بتلك المحاولة، تاركةً ابنها دون تعليم، وبعد صمتٍ ساد لدقائق، قالت الأم إن عدم تعلّم ابنها ليس بالأمر الجلل، فإنه حين سيكبر قليلاً، سيتمكّن من العمل في أيّة مهنة متوفرة ليكسب قوت يومه، ليبقى اللعب في الحي هو ما سيفعله عمران إلى أن يحين الوقت الذي يجب فيه أن ينخرط في أيّة مهنةٍ تُتاح له.
طفل آخر ترك مقاعد الدراسة في سنٍّ مبكّرة، ففي أحد أحياء بلدة الشدادي، تُرى رنا التي طلبت عائلتها استخدام اسم مستعار للحديث عن قصتها، جالسةً بجانب والدها في سوقٍ شعبي وسط منطقة مركدة التابعة للشدادي، وتساعده في بيع بعض المنتوجات، وتكمل ما تبقّى من يومها في القيام بالأعمال المنزلية.
تبلغ رنا من العمر 17 عاماً، توقفت عن الدراسة عند وصولها إلى نهاية المرحلة الإعدادية، مشيرةً إلى أنّها اكتفت بتعلّم القراءة والكتابة، وبعض العمليات الحسابية، و دلم تفكّر يوماً أن تحصل على شهادة علمية وتتوظف على إثرها. تقول رنا “أشعر بالراحة في الأعمال المنزلية، لكنني أفتقد وجود صديقات من حولي كما كنّ في المدرسة، ولا أخفي ندمي في بعض الأحيان على ترك الدراسة.”
تتراجع رنا بعد لحظات عن رأيها، لتبيّن أنها نادمةً بالفعل على ترك الدراسة، وتشعر بشيءٍ من الحسرة حين ترى الطلاب والطالبات يتوجهون/ن إلى المدارس صباح كل يوم، في الوقت الذي لم تُبدِ عائلتها أيّ موقفٍ من قرارها لترك الدراسة، وأنهى والدها الحديث بقوله “معلش، بكرا تتجوز وزوجها يصرف عليها.”
الحرمان من التعليم مهدد مستقبلي للسلام
لا يمكن حصر المدرسة بتعليم القراءة والكتابة فقط، بل إنّها عمليات تفاعلية مع بيئة كبيرة، تساهم في اكتساب الطفل/ة قدرات، وعادات، ومعارف، وذكريات عاطفية واجتماعية، يمكن البناء عليها في مراحل عمرية لاحقة، بحسب ما توضحه زينب زبيدي (مديرة تقنيّة للصحّة النفسية والدعم النفسي في منظّمة الإنسانيّة والدمج)، وتشير زينب إلى أن الحرمان من هذه العوامل، يؤثّر على صعوبة تطوير لغة الطفل/ة، وقدرته/ها على التعبير عن نفسه/ها، كما يمكن أن ي/تواجه صعوبات في المستقبل في المطالبة بالخدمات على مختلف الأصعدة، في ظل ضعف المعرفة بالحقوق والواجبات، ما يُنتج أفراداً ضعيفي/ات الدور في الإنتاج مجتمعياً.
“إنّ إهمال تعليم الأطفال من قبل الأهل سيسبب نتائج وآثار اجتماعية واقتصادية ونفسية على المدى القريب والبعيد، حيث يخلق جيل يشعر بضعف الثقة، والنقص في الإمكانيات، ويشعر الطفل بهذه الأمور في مختلف المراحل العمرية.” تقول زينب وتوضّح أن تضاعف المشاعر السلبية جرّاء الحرمان من التعليم يُشعر الشخص بحالة من العزلة وعدم الاندماج مع المجتمع، لذا يمكن أن يتعامل الشخص المحروم/ة من التعليم مع مختلف مشكلاته/ها بالعنف نظراً لفقدانه/ها المهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات، وتؤكّد زينب إنه من الضروري التحذير بأن أي مجتمع لا يتعامل مع التعليم كأولوية يعرّضه لسهولة الاعتداء عليه وتفكيكه من حالة التماسك على مختلف الأصعدة.
“أحببت المواد العلمية، وتفوقتُ فيها، وطمحت لدخول كلية الهندسة، لكن للعادات والتقاليد رأي آخر.” بهذه الجملة وصفت آية المحمود (18 عام) من ريف بلدة تل كوجر/اليعربية حرمانها من التعليم، فقد وصلت آية للصف الثامن، حين بدأت عائلتها تضغط عليها لترك الدراسة، امتثالاً لبعض العادات والتقاليد السائدة في منطقتها.
تقول آية إنّ هذه العائدات تقتضي منع الفتيات الخروج من القرية سوى إلى بيت الزوجية، لذا ونظراً لأن المدرسة الوحيدة في القرية توفّر الدراسة للمرحلة الإعدادية، فإنها حُرمت من إكمال تعليمها، ونظراً لأنها الابنة الأكبر للعائلة، استوجب وجودها لجانب والدتها للمساعدة في الأعمال المنزلية، ولم يقتصر الأمر عليها فقط، فإن غالبية الفتيات من صديقاتها في المدرسة حُرمن من التعليم، وباتت وظيفتهن القيام بالأعمال المنزلية إلى حين تزويجهن، بحسب ما توضحه آية وتقول: “عادة الخوف على البنات بمجتمعنا، خنقتنا وحرمتنا من تحقيق طموحاتنا.”
وعلى بعد ما يقارب من 180 كم عن المكان الذي تقطنه آية، يجلس علي في مكان عمله بالمنطقة الصناعية في بلدة الشدادي، ذاك المكان الذي يقضي جّل وقته فيه. يبلغ علي من العمر 16 عاماً، ولم يحدث أن دخل المدرسة يوماً، حيث شهدت بلدته الكثير من المعارك والحالات الأمنية غير المستقرة نتيجة خضوعها لحكم تنظيم “الدولة الإسلامية”، الأمر الذي منع علي من تلقّي التعليم، واستمر الأمر إلى أن بدأ العمل في مهنة تصليح السيارات، ليساعد في إعالة عائلته، وفقد الأمل من قدرته على تلقّي التعليم من جديد.
“أفكّر دوماً في المعرفة التي حُرمتُ منها، وما الذي يفوتني الآن في الصفوف المدرسية، وما الذي كنت سأصبح عليه إن تلقّيتُ التعليم؟” أسئلة متكررة تزور مخيّلة علي أثناء أوقات الراحة في العمل، وتتبدد عند مناداته ليعود للعمل من جديد.
يقول مصطفى فرحان الرئيس المشترك لـ”هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة” (تابعة للإدارة الذاتية)، إنّ عوامل عديدة تؤثّر على محاولاتهم/نّ ضمان حصول جميع أطفال وطفلات المنطقة على التعليم بكافة مراحله، ولعلّ أهم هذه العوامل بحسب وجهة نظر مصطفى هي حالة عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها المنطقة بين الفترة والأخرى، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بأهالي المنطقة.
ويشير مصطفى إلى أنّه وعلى الرغم من وجود قانون إلزامية التعليم لدى “هيئة التربية والتعليم في شمال شرقي سوريا” إلا أنّ الأزمة الاقتصادية من أهم التحديات أمام تطبيقه، لذا فإنه يستوجب العمل على تحقيق الاستقرار الأمني، وتحسين الوضع الاقتصادي حتى يتسنّى لـ”هيئة التربية والتعليم” ضم كل الأطفال والطفلات لصفوف الدراسة، منوّهاً إلى أنه حتى الآن لا توجد ضمن مشاريعهم/نّ أية برامج لمحو الأمية للأناس الذين/اللواتي حرموا/ن من التعليم نتيجة ظروف الحرب، ومن الممكن أن تُدرج هذه البرامج في خططهم/نّ المستقبلية.